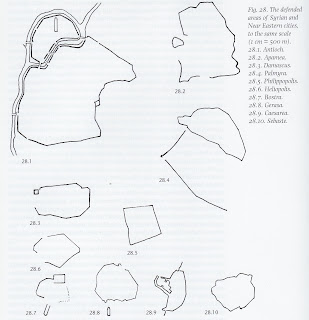ولد فيليپ خوري في الولايات المتحدة الأمريكيّة وتلقّى قسماً من تعليمِهِ في الجامعة الأمريكيّة في بيروت وحصل على شهادة الدكتوراة من جامعة هارڤارد عام ١٩٨٠، ليصبح بعدها أستاذاً للتاريخ في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا. أقوم اليوم بتقديم كتابين له من ثمانينات القرن العشرين، وهما من أفضل ما نُشِر عن التاريخ السياسي لسوريّا الحديثة قبل عهد الاستقلال.
صدر الكتاب (الجزء إذا شئنا) الأوّل بعنوان "أعيان المدن والقوميّة العربيّة، سياسات دمشق ١٨٦٠-١٩٢٠" عام ١٩٨٣ عن منشورات كمبريدج. الكتاب صغير الحجم نسبيّاً، عددُ صفحاتِهِ حوالي١٥٠، يبدأ بمجزرة ١٨٦٠ وينتهي بدخول الفرنسييّن إلى دمشق وطرد الملك فيصل. جرت نكبة ١٨٦٠ على خلفيّة استياء علماء المسلمين من التنظيمات العثمانيّة، وامتعاض الحرفييّن العاطلين عن العمل نتيجةً لمنافسة البضاعة الأوروپيّة المصنّعة والرخيصة، وغيرها من الأسباب غير المباشرة، التي أدّت إلى النقمة على مسيحيّي دمشق الموسرين نسبياً، إذ خلطت الدهماء بينهم وبين المصالح الأجنبيّة. علاوةً على الأرواح التي أُزْهِقَت والدمار الذي لحق بالحيّ المسيحي، نَتَجَ عن المذبحة إعادة تنظيم أعيان دمشق وبروز وجوه جديدة أكثر انسجاماً مع سياسات القسطنطينيّة وأسرع مطواعيّةً في تطبيقِها، واستمرار هذا النهج الجديد على الأقلّ حتّى ١٩٠٨ وسقوط السلطان عبد الحميد المتزامن مع صعود جمعيّة الاتحاد والترقّي وتركيّا الفتاة.
لعب مثقّفو المسيحييّن ومُفَكِّروهم دوراً جوهرياً في العروبة العلمانيّة كمفهومٍ ثقافي قبل عام ١٩١٤، وثانويّاً في العروبة السياسيّة. كانت العروبةُ وَقْتَها بدعةً سوريّةً بامتياز، اختَرَعتها نخبةٌ صغيرةٌ من أهل المدن السوريّة، خصوصاً دمشق، ومع ذلك يتعيّن توخّي الحذر في تقييم أهميّتها، وألّا ننسى أنّ الغالبيّة العظمى من مقاتلي فيصل كانت حجازيّةً وعراقيّة، وأنّ معظم السورييّن تعاطفوا مع الدولة العثمانيّة، وكثيرٌ منهم اعتبروا الثورة ضدّها خيانةً وحاربوا معها طوعاً أو قسراً، أو على الأقلّ وقفوا على الحياد بانتظار نتيجة الصراع.
******
رأى الكتاب (أو الجزء) الثاني "سوريّا والانتداب الفرنسي، سياسات القوميّة العربيّة ١٩٢٠-١٩٤٥" النور عام ١٩٨٧، والناشر هذه المرّة جامعة پرنستون. هذا العمل بمثابة تتمّة للكتاب الأوّل، بيد أنّه أطول بكثير (حوالي ٧٠٠ صفحة) وأغنى بالتفاصيل، رغم كون الفترة الزمنيّة التي يغطّيها لا تتجاوز ربع القرن، بدايةً من ميسلون ودخول غورو، ونهايةً بجلاء الفرنسييّن عن سوريّا. العمل موجّهٌ بالدرجة الأولى للمختصّين ويحتوي على كمٍّ لا بأس به من المعلومات عن الإدارة الفرنسيّة والإحصاءات.
بعد التعريف ببعض أعلام المقاومة كإبراهيم هنانو والشيخ صالح العلي وعبد الرحمن الشهبندر، يتعرّض الدكتورخوري إلى خلفيّات الثورة السوريّة الكبرى ١٩٢٥-١٩٢٧، وكيف بدأت القلاقل في جبل الدروز عندما اعتقل الفرنسيّون اللبناني أدهم خنجر بتهمة المشاركة بمحاولةٍ لاغتيال الجنرال غورو. كان خنجر في طريقه إلى زيارة سلطان الأطرش الذي طالب السلطات الفرنسيّة بتسليمه الأسير احتراماً للأعراف العريقة للضيافة الدرزيّة، وعندما لم يستجب الفرنسيّون إلى التِماسِهِ، هاجم الدروز القافلة الموكلة بنقل خنجر إلى دمشق.
لا مجال للدخول بتفاصيل الثورة التي انتشرت من جبل الدروز إلى دمشق وغيرها، وحسبنا تسليط الأضواء على بعض الحوادث التي لا تُطابِقُ بالضرورة السرد التقليدي لثورةٍ وطنيّة ضدّ الاستعمار الغاشم، ولا تخلو من بعض الجوانب المظلمة التي يَضْرِب عنها صفحاً الكثيرون من الرواة. قصف وتدمير حيّ سيدي عامود (الحريقة) من قبل الفرنسييّن معروف؛ أقلُّ شهرةً منه قتل مسلحيّ حسن الخراط للجنود المغاربة في أحد مواخير الشاغور (صفحة ١٧٦)، ونهب الثوّار لقصر العظم، والهلع الذي أصاب مسيحيّي باب توما عندما انسحب الفرنسيّون، ودخول الأمير سعيد الجزائري إلى هذا الحيّ مع مجموعةٍ من المسلّحين في محاولةٍ منه لحماية الأهالي من العصاة واللصوص، أسوةً بسلفه الأشهر الأمير عبد القادر قبل خمساً وستّين من الأعوام. يترتّب على ما سبق تعدّد عوامل الثورة التي اختلط فيها الوطني مع الشخصي مع الديني والقَبَلي والعشائري والإقليمي.
بدأت مرحلةٌ جديدةٌ في العلاقات الفرنسيّة السوريّة بعد أن وضعت الثورةُ أوزارَها، في محاولةٍ من البعض للتعاون مع سلطات الانتداب وإنقاذ ما يمكن إنقاذُهُ بالطرق الپرلمانيّة والمفاوضات؛ تزامن هذا مع صعود الكتلة الوطنيّة. لاحَ الفَرَجُ قريباً عندما وصلت الجبهة الشعبيّة بزعامة ليون بلوم إلى سدّة الحكم في فرنسا إذ أبدت وزارةُ هذا الأخير استعدادَها لبحث مستقبل سوريّا عن طريق رَبْطِها بفرنسا بمعاهدة (١٩٣٦) تحلُّ محلَّ الانتداب. كان لليمين الفرنسي الاستعماريّ الهوى الباع الأطول في إحباط هذا المسعى، عندما رفض الپرلمان الفرنسي تصديق الاتّفاقيّة رغم تنازلات المفاوض السوري جميل مردم بك (التي رفضها الپرلمان السوري بِدَوْرِهِ). بالنتيجة أتى إضراب ١٩٣٦، وتبخّر ما تبقّى من الأمل بعد سقوط حكومة بلوم.
قصّة سلخ لواء اسكندرون لخطب ودّ تركيّا قبيل الحرب العالمية الثانية، والتحدّي الصهيوني في فلسطين وأصداء هَذَيْن الحَدَثَيْن في سوريّا، معروفةٌ لا يمكن اختزالها في سطورٍ قليلة. خَرَجَت فرنسا من الصراع العالمي الجديد منهكةً، واستطاع سياسيّو سوريا توظيف هذا الضعف لصالحهم، بدعم من الإنجليز الذين مارسوا الضغط على فرنسا وفرضوا عملياً جلاء قوّاتِها عن بلاد الشام.